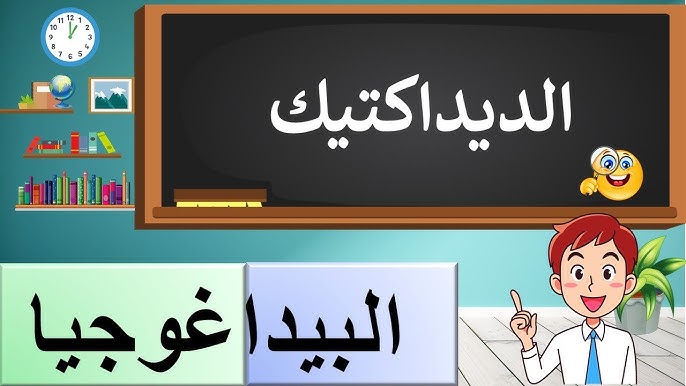
1-التعليميات المصطلح و المفهوم:
إن التعليميات أو التعليمية و هي فن التدريس أو الديداكتيك أو علم التدريس أو منهجية التدريس قبل أن نقف إلى مفهوم المصطلح المركب نقف عند أحد أجزائه و هو التعليم أو التدريس، 1.1.فالتعليم أو التدريس "هو عملية تفاعل بين المعلم و الطلاب تسعى لتحويل الأهداف و المعلومات النظرية و المنهجية إلى كفايات معرفية ، وقيمية و اجتماعية و حركية مفيدة للتلاميذ و المجتمع"[i]، فمن خلال هذا التعريف الذي يقف عند قطبي التدريس أو طرفاه الاساسيان و هما المعلم والمتعلم فالمعلم يسعى إلى بناء شخصية المتعلم و التأثير فيه فيكون بذلك التدريس فن و علم .
فهو فن من خلال ما يبديه المعلم من براعة وقدرات ابتكارية وجمالية أو بلاغية لغوية فهو خطيب موهوب يدفع بالمتعلمين إلى أن يكونوا أكثر استعدادا للتفاعل مع المعلم و بذلك يصبح الموقف التعليمي أعمق أثرا، و كذلك فنا من خلال التعامل الانساني الذي يبديه المعلم فهو فن فيما يقوم به نحو طلابه.
أما كون التدريس يعتمد على أسس علمية فإنه يكون بذلك علما كبقية العلوم الاخرى و نظاما كغيره من الأنظمة له مدخلاته و عملياته و مخرجاته :
-المدخلات: (inputs) الأهداف المناهج الوسائل التعليمية .
-الخطوات أو العمليات: (processes) تتمثل في التدريس بأهدافه و استراتيجياته، وأساليبه و طرائقه و بأساليب التقويم و تحضير البيئة الصفية و التنفيذ و تحسين التدريس و يكون ذلك من خلال التغذية الراجحة.
-المخرجات: (outputs) تتمثل فيما تحقق من الأهداف التي رسمها المعلم أو فيما تم تحقيقه من الأهداف العامة للتربية.
-ثم تأتي بعد ذلك التغذية الراجحة (feedback)التصحيح و التوجيه في العملية التعليمية والتي يكون من نتائجها عمليات الاستمرار أو التعديل أو الاستبدال في أي مرحلة من المراحل السابقة كما في المخطط:[ii]
|
المدخلات inputs |
|
العمليات processes |
|
المخرجات outputs |
|
|
التغذية |
|
الراجحة |
|
|
|
|
مدخلات: معلم منهج متعلم
عمليات: استراتيجيات أساليب طرق
مخرجات: أهداف تحققت و خبرات اكتسبت، و تغذية راجحة تربط بين هذه العناصر.
فالتدريس كأي نشاط متقن يحتاج للعلم و الفن ممتزجان، فالعلم يزودنا بفهم واضح لطبيعة عملية التدريس و أحداثه و متغيراته و كيفية التخطيط و التنفيذ و التقويم له، في حين أن الفن يزودنا بأسس التعامل مع هذه المتغيرات و الأحداث بشكل سريع و فوري اعتمادا على سرعة البديهة و فن التصرف و البصيرة النافذة و غيرها مما يقع في نطاق الفن، فهو بذلك عملية تفاعلية ديناميكية اتصالية (communication precess) ما بين المعلم و المتعلم[iii].
2.1.بين التعليم و التعلم:
أورد دوغلاس براون[iv] تعريفا للتعليم و التعلّم و كيف يتفاعلان:
-التعلم أن تحصل أو تكسب معرفة عن موضوع أو مهارة عن طريق الدراسة أو الخبرة أو التعليم.
-التعلم تغيير مستمر نسبيا في الميل السلوكي و هو نتيجة لممارسة معززة.
أما التعليم فهو مساعدة شخص على أن يتعلم كيف يؤدي شيئا ما أو التزويد بالمعرفة أو الدفع للفهم و المعرفة.
فالتعليم و التعلم كما يرى دوغلاس من المفهومات المعقدة لأن كلاهما يفضي إلى مجالات فرعية أخرى خاصة علم النفس:
-فالتعلم الاكتساب و الحصول
-التعلم الاحتفاظ بالمعلومات أو بمهارة ما.
-الاحتفاظ يتطلب أنظمة الاختزان و الذاكرة.
-التعلم مستمر نسبيا لكنه معرض للنسيان
-يضمن التعلم شيئا من الممارسة.
-التعلم تغيير في السلوك.
أما التعليم فلا يمكن تعريفه منعزلا عن التعلم ذلك أن المتطلبات العلمية للتعليم لا تتحقق إلا بوضوح نظريات التعلم.
-فالتعليم تيسير التعلم و توجيهه و تمكين المتعلم منه و تهيئة الأجواء له.
فالتعليم هو التدريس و هو مقابل للتعلم إذ نقول علمته العلم فتعلم، و العملية التعليمية التعلّمية متكاملة إذ يقوم المعلم بالتعليم من طرف، و يقوم المتعلم بالتعلم من طرف آخر.
فمهوم التعليم يتضمن الحاجة إلى معلم في حين أن التعلم لا يتضمن الحاجة إلى ذلك، لأن المتعلم يستطيع تحصيل العلم بنفسه معتمدا على ذاته.
و يمكن أن نسجل مجموعة من الفروق بين التعليم و التعلم فيما يلي:
|
التعليم |
التعلّم |
|
- التعليم محددا بالمكان و الزمان مثل التعليم في المدرسة أو الجامعة. - يكون عبر مراحل معينة و يتوقف في فترة من الفترات - التعليم لا يصلح إلا بوجود طرفين معلم متعلم -التعليم أسئلة و أنشطة و اختبارات - التعليم غالبا ما يكون غير ذاتي. -التعليم لا يكون إلا للحسن. |
- يكون في كل وقت و في كل مكان - مستمر مدى الحياة - التعلم للمتعلم فلا يوجد معلم - التعلم يكون ذاتي أو غير ذاتي - التعلم للسيئ و الحسن. |
2.1. الديداكتيك:
ديداكتيك في اللغات الأوربية مشتقة من (diacticos) و تعني فلنتعلم أي يعلم بعضنا بعضا والمشتقة أصلا من الكلمة الاغريقية(diaskein) ومعناها التعليم، وقد استخدمت هذه الكلمة في التربية أول مرة كمرادف لفن التعليم وقد استخدمها كومينوس أو كومينسكي (J.A.Cominius dit Comensky)1592-1670 الذي يعد الأب الروحي للبيداغوجيا في كتابه الديداكتيك الكبرى(diactica magna)[v] حيث يعرفها بالفن العام للتعليم في مختلف المواد التعليمية ويضيف بأنها ليست فنا للتعليم فقط بل للتربية أيضا[vi].أما في موسوعة لالاند الديداكتيك "جزء من علم التربية موضوعه التدريس"[vii].
و قد استعمل المصطلح في اللغة العربية بعدة ترجمات مقابلة للمصطلح الأجنبي فنجد التعليمية وهو المصطلح الرائج في المدرسة الجزائرية أما في المغرب فتعرف بعلم التدريس أو الديداكتيك و
في تونس تعليمية المواد و تعرف بتطوير التعليم في كل من مصر و الأردن[viii].
أما في المفهوم الاصطلاحي فالديداكتيك شق من البيداغوجيا –ذلك الحقل المعرفي الذي يهتم بالممارسة التربوية في أبعادها المتنوعة – موضوعه التدريس، فتعريف الديداكتيك لا يستقسم بعيدا عن البيداغوجيا و خارج مضلتها عرفها الدريج بقوله: نقصد بالديداكتيك أو علم التدريس الدراسة العلمية لطرق التدريس و تقنياته ، و تنظيم مواقف التعلم التي يخضع لها التلميذ في المؤسسة التعليمية قصد بلوغ الاهداف المسطرة سواء على المستوى العقلي أو الوجداني أو الحسي الحركي.[ix]
[i] -علم الدين عبد الرحمن الخطيب، أساسيات طرق التدريس، منشورات الجامعة المفتوحة 1997،ص18،19.
[ii] -نفسه،ص20.
[iii] -ينظر سهيلة محسن كاظم الفتلاوي، المدخل إلى التدريس، سلسلة طرائق التدريس، دار الشروق، عمان الاردن، 2010، ص22-23.
[iv] -دوجلاس براون، أسس تعلم اللغة و تعليمها، ترجمة عبده الراجحي، و على أحمد شعبان، دار النهضة العربية ،بيروت لبنان، ص25 و ما بعدها.
[v] -diactica magna(1621-1657) johanis amos comenius :Jean Amos Coménius. La Grande didactique : Traité de l'art universel d'enseigner tout à tous. Introduction et traduction par J.-B. Piobetta, Presses Universitaire de France.
[vi] -ينظر محمد الدريج، دداكتيك اللغات و اللسانيات التطبيقية، منشورات مجلة كراسات تربوية، المغرب ص14 و ما بعدها
[vii] -أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، منشورات عويدات، بيروت، باريس، ص276.
[viii] -بعلي الشريف حفصة، التعليمية، مجلة الباحث، جامعة الوادي، العدد1 يونيو2010، ص6.
[ix] - ينظر محمد الدريج، عودة إلى تعريف الديداكتيك و علم التدريس مجلة علوم التربية عدد 47 مارس 2011 ص11.
و ينظر ايضا علوم التربية ملخصات التربية، منتدى فضاء تعليمي الرابط: taalimi.info
https://www.taalimi.info/2019/11/blog-post_13.html
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاضرة: االمفاهيم المؤسسة للديداكتيك:
يتأسس الديداكتيك على ثلاثة مفاهيم أساسية :
1..التعاقد الديداكتيكي(le contrat didactique) : لقد كان للرياضي كي بروسو (Guy Brousseau) الفضل في تطوير نظريات الوضعيات الديداكتيكية (la théorie des situations didactiques) مؤكدا على مصطلح العقد الديداكتيكي الأنموذج المقترح لتدريس الرياضيات للأطفال الذين ظهر عندهم عجز في الاكتساب و صعوبات التعلم و غياب الاقبال على درس الرياضيات على خلاف نجاحهم في المواد الأخرى و معاينة الصف الذي ظهر فيه العجز و قد عرفه بروسو " مجموع سلوكات المدرس المرتبطة ببناء المعرفة واكتسابها والمتوقعة من طرف المتعلمين، ومجموع سلوكات المتعلم المتوقعة من طرف المدرس. إنه مجموع القواعد التي تحدد، بصورة ضمنية، ما يتوجب على كل شريك في العلاقة الديداكتيكية، تدبيره وما سيكون موضوع محاسبة أمام الأخر".[i]
اذن في اطار تفاعل زوايا المثلث الديداكتيكي( مدرس- متعلم- معرفة) يعتبر العقد الديداكتيكي بمثابة الزام يحدد، بصفة ضمنية في الغالب، ما هو مطلوب من كل طرف ( المدرس والمتعلم) أن يقوم به من خلال العملية التعليمية التعلمية، كما يحدد مستويات المسؤولية المسندة لكل منهما من خلال مجموعة من البنود التي تنظم وتضبط العلاقة التي تربط المدرس و المتعلم .حتى وان كانت بنوده غير معلنة أو غير مصرح بها، فإن التعاقد الديداكتيكي حاضر في كل عملية تعليمية – تعلمية.
و هناك فرق بين العقد الديداكتيكي و العقد البيداغوجي(contrat pédagogique) حيث يركز الأول على الأدوار والوظائف التي ينبغي أن يلتزم بها كل طرف أثناء عملية اكتساب المعرفة، وتحقيق الأهداف المتوخاة من النشاط التعليمي التعلّمي، أما العقد البيداغوجي يركز بالخصوص على ما يعتبره بروسو اجتماعيا في العلاقة بين الطرفين : كالالتزام بالانضباط داخل الفصل، واحترام الوقت واقتناء الأدوات المدرسية وعدم الغش.
2..النقل الديداكتيكي (la transposition didactique): أما المقصود بالنقل الديداكتيكي ، فهي تلك العملية التي يقوم بها المدرس من أجل نقل المعرفة من إطارها الأكاديمي إلى معرفة قابلة للتدريس يراعي فيها المستوى التعليمي للمتعلمين المراد تلقينهم تلك المعرفة:[ii] أي نقل المعرفة من مجالها العالم (Savoir savant)، من أجل تبسيطها وتحويلها إلى معرفة قابلة للتدريس للتدريس[iii]."
و بذلك تكون لدينا مسارات للمعرفة من خلال عملية النقل الديداكتيكي تشمل[iv]:
- المعرفة العالمة: Savoir savant هي المعرفة التي أنتجها الباحثون المختصون، فهي غير قابلة للتدريس وفق شكلها الأصلي، إذ يصعب إدراكها من طرف المتعلم، لذا تستدعي المقتضيات التعليمية نقلها من إطارها العالم إلى إطار ديداكتيكي، إلا أن عملية النقل هاته تؤثر على قيمة هذه المعرفة.
- المعرفة المدرسة: Savoir enseigné تتمثل فيما يقدمه المدرس لمتعلميه داخل القسم اعتمادا على المعرفة المدرسية (المنهاج الدراسي، الكتب المدرسية، التوجيهات التربوية، المذكرات الوزارية، الملتقيات التربوية والتكوينية....
- المعرفة المكتسبة: Savoir acquis أي المعرفة التي اكتسبها المتعلم، وهي معرفة لا تعكس بالضرورة ما درسه الأستاذ، حيث أن المتعلم في محاولته لاستيعاب المعرفة المدرسة من طرف المدرس، يمارس بدوره عملية ذهنية على ما يتلقاه، أي أنه يؤول ويعيد تنظيم مكتسباته وفق تصور جديد.
3..المثلث الديداكتيكي(triangle didactique) : و يقصد به تلك الوضعية التعليمية التي تجمع بين ثلاث عناصر أساسية في علمية التعلم وهي : المدرس – المتعلم – المعرفة ، ويوضح علاقة كل عنصر من هذه العناصر بالعنصرين الاخرين.
- علاقة المتعلم و المعرفة : يهتم البحث الديداكتيكي في إطار هذه العلاقة بالآليات العلمية السيكولوجية التي تخول للمتعلم اكتساب المعرفة .فهم ادراك تفاعل
- علاقة المدرس و المعرفة : يهتم البحث الديداكتيكي في إطار هذه العلاقة بالسبل و الآليات التي يمكن للمدرس اتباعها من أجل تحقيق نقل ديداكتيكي ناجع .
- علاقة المدرس و التلميذ : حيث يهتم البحث الديداكتيكي في هذه العلاقة بتفعيل الجانب البيداغوجي تطبيقيا ، وذلك في إطار ما يسمى بـ ” التعاقد الديداكتيكي “.
نلخص أدوار الثالوث الديداكتيكي من خلال الرسم أدناه:[v]
4.2.أنواع الديداكتيك:
ميّز لوجوندر(R.Legendre) في القاموس المعاصر للتربية بين ثلاث مستويات للديداكتيك :
1.الديداكتيك الخاصة(didactique de la discipline) أو (Didactique spéciale) : تهتم بكل مادة على حدى وذلك بحسب التخصص ، والاطلاع على الديداكيك الخاص يكون على حسب احتياجات كل مدرس وطبيعة تخصصه ومادته المدروسة. أي تخطيط عملية التدريس أو التعلم لمادة دراسية معينة .
2.الديداكتيك العامة(Didactique générale) : مجموع المعارف التعليمية القابلة للتطبيق في مختلف المواقف أي مجموع المواد التعليمية، يشترك فيها كل المدرسين رغم اختلاف تخصصاتهم ، فهي تعالج طرائق التدريس بصفة عامة وليس محصورا في متطلبات مادة بعينها.
3.الديداكتيك الأساسية: تشمل الأسس العامة أو الجانب النظري دون الالتفات إلى الممارسة التطبيقية و تسمى كذلك الديداكتيك النظرية حسب ليجوندر (didactique fondamentale).
الانزلاقات الديداكتيكية:
قد يسقط المدرس أحيانا في بعض الانحرافات في بنائه للوضعيات التعلمية مما يكون له تأثير سلبي على العقد الديداكتيكي فيتكون ما يسمى بالانزلاقات الديداكتيكية (échappatoires didactiques) أو الآثار الديداكتيكية: منها
- أثر توباز: Effet Topaze
يتجلى هذا الأثر عندما يصادف التلميذ صعوبة، فعوض أن يواجه تلك الصعوبة بالاعتماد على مجهوده الذاتي يتدخل المدرس ويقدم مساعدة حاسمة، الأمر الذي يفوت عليه فرصة بناء تعلماته. في هذه الحالة لا يقوم التلاميذ بالجهد اللازم لاكتساب المعرفة المنشودة، وبالتالي لا يتحقق الهدف.
-أثر جوردان: Effet Jourdain.
ويسمى كذلك بسوء الفهم الأساسي ،ويحدث عندما يتجنب المدرس النقاش مع التلاميذ حول المعرفة. فحتى لا يقع في الفشل، يكتفي يتقبل أدنى إشارة بسيطة يبديها المتعلم، معتبرا إياها دليلا على فهمه واستيعابه لما قدم له، حتى وان كانت سلوكات أو إجابات التلاميذ غير مقتنعة وساذجة.
-الانزلاق الميتا معرفي: le glissement métacognitif
عندما يفشل المدرس في اكتساب ما يريد اكتسابه للمتعلمين، يهتدي الى تبرير ما، فيتحول إلى موضوعات أخرى ، مستبدلا بذلك موضوع المعرفة المقررة الذي يشكل المحور الفعلي لنشاطاته.
كانت هذه أمثلة لبعض الانزلاقات الي قد يقع فيها المدرس/ مما يؤثر بالتالي سلبا على العقد الديداكتيكي، بينما هناك انزلاقات أخرى تحدث عنها دارسو الديداكتيك مثل:
-الاستعمال المفرط للماثلة L’usage abusif de l’analogie ،-و أثر الانتظار الغامض L’effet de l’attente incomprise...-شيخوخة الوضعيات التعلمية و غيرها...[vi]
[i] -نقلا عن زين العابدين مغربي، العقد الديداكتيكي في الدرس الفلسفي، مجلة منتدى الأستاذ ، المدرسة العليا للأساتذة قسنطينة، العدد13، 2013، ص56.
[ii] -عبد الله كثيف، ماقل و دل في علوم التربية ،وزارة التربية و التكوين المملكة المغربية2018، مدونة الأستاذ ، تاريخ النشر 25-11-2018، الرابط: https://www.lilostad.com/2018/11/pdf_14.html
[iii] -استخدم هذا المصطلح أول مرة في ديداكتيك الرياضيات مع شوفالار الذي ألف كتاب تحت عنوان النقل الديداكتيكي من المعرفة العالمة إلى المعرفة المدرسة Chevallard (Yves). — La Transposition didactique: du savoir savant au savoir enseigné
[iv] -ينظر النقل الديداكتيكي، مدونة الملتقى التربوي، تاريخ النشر19 يونيو 2020،
الرابط: https://modawanaty91.blogspot.com/2020/07/transposition-didactique.html
[v] -نفسه
[vi] - ينظر د.أحمد الفاسي، الديداكتيك مفاهيم و مقاربات، منشورات جامعة عبد المالك السعدي، المدرسة العليا للأساتذة، تطوان، المغرب ص12-13.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاضرة: -إعداد المعلم:
تمهيد:
يعد المعلم طرفا فاعلا في تحقيق أهداف التربية و لهذا صار من الضروري إعداده من أجل الآداء الجيد لمهنته و القيام بأعباء تنشئة الاجيال، فمهام المعلم لم تعد قاصرة على نقل المعرفة و إنما هو مسؤول على العديد من الأدوار فهو باحث و مصمم للخبرات التعليمية و التكنولوجية و مرشد و مقوم و قائد للعملية التعليمية بصفة عامة.
فكل هذه الأدوار إنما هي في سبيل إتاحة خدمات تعليمية لفئة المتعلمين في جميع الأطوار، فالحاجة ملحة لرفع كفاءة و آداء المعلم و لا يتأتى ذلك إلا باستخدام استراتيجيات و مداخل حديثة و مبتكرة.
و قد صنفت بعض البحوث التربوية[i] إعداد المعلمين إلى صنفين:
1-إعداد المعلمين قبل الخدمة: و هو جميع الخبرات التي تقدم للمتعلم تحت إشراف المؤسسة التعليمية ، و هو أيضا مجموع الخبرات المهارية و الوجدانية المتنوعة التي توفرها الكليات لطلبتها خلال المقررات المتخصصة و التربوية ومقررات الثقافة العامة بما يمكنهم من القيام بعملية التدريس. ومراعات عدة جوانب منها الجانب الاكاديمي و الثقافي، الجانب التربوي المهارات المواقف الجانب الاجتماعي و غيرها.
2-إعداد المعلمين أثناء الخدمة: و تبدأ هذه المرحلة بعد الانتهاء من الاعداد الاكاديمي في مؤسسات إعداد المعلمين، و هو نشاط هادف قائم على التدريب لاستكمال القصور في مرحلة إعداد المعلم في المؤسسات كتدريب تكميلي، و هناك تدريب علاجي معالجة القصور أو ضعف في أحد الكفايات، أما التدريب التجديدي غايته مسايرة المستجدات و التطورات.
فتدريب المعلمين أثناء الخدمة غايته مواكبة التطور و التجديد؛ تطور المناهج التربوية، تجديد الخطط التربوية، معالجة النقص الحاصل في فترة الاعداد، تحسين آداء المعلم، و النمو المهني و الترقية.
2..مفهوم إعداد المعلم:
-الإعداد صناعة أولية للمعلم كي يزاول مهنة التعليم و تتولى ذلك مؤسسات تربوية متخصصة مثل معاهد إعداد المعلمين و كليات التربية و غيرها.
-الاعداد في اللغة التهيئة و التحضير و في التربية مجموعة المعارف و المفهومات و الخبرات المتنوعة التي تقدمها مؤسسات ما لمجموعة من المعلمين بشكل يؤدي إلى تعلمهم و تكوينهم.
2.2.أهداف إعداد المعلم:
يهدف إعداد المعلم بشكل جوهري إلى تحقيق غايات تعليمية يمكن إجمالها فيما يلي:
-إكساب الطالب المعلم المهارات اللازمة للتدريس في مجال تخصصه.
-إعداد الطالب المعلم نفسيا و تربويا للقيام بمسؤولياته المهنية بعد التخرج.
-التطبيق العملي للأسس النظرية التي درسها في مقررات الاعداد التربوي.
-إكساب الطالب المعلم الخبرات الأساسية و المتطورة في إدارة الفصل().
-إحداث تغيرات إيجابية في شخصية الطالب المعلم.
-الاسهام الفاعل في الأنشطة المدرسية المختلفة.
2.3. خصائص و أدوار المعلم:
إن اختيار المعلم يخضع لعملية انتقائية ذات ضوابط و معايير محددة، و من البديهي أن تتوفر فيه مواصفات عقلية و جسمية و انفعالية و نفسية و اجتماعية و مهارات النمو المهني، فضلا عن الشهادة الجامعية و يمكن اختصار بعض الخصائص التي يجب توفرها في المعلم و هي[ii]:
أ-الخصائص الجسمية: ان يكون خال من الامراض و العاهات التي تقف عائقا أمام أداء مهامه، أن يكون مهتما بحسن مظهره و كمال هيئته فغالبا ما ينبئ المظهر عن الجوهر.
ب-القدرات العقلية: التفكير العلمي الذكاء الابداع المادة المعرفية لمساعدة طلبته على النمو العقلي و حل المشكلات و تدريس مادته العلمية على اكمل وجه.
ج-الشخصية: قوة الشخصية و القدرة على التحكم في سلوكه و الاتزان الانفعالي و الشجاعة الأدبية و التعاون مع الآخرين.
د-الخصائص الأكاديمية و المهنية: التعمق في مجال التخصص و الاطلاع الدائم للكتب و الدوريات و حضور المؤتمرات و الندوات و غيرها.
ه-التمسك بالقيم: القيم الدينية و الاجتماعية دون تعصب، و أخلاقيات المهنة.
و يضاف إلى هذه الخصائص مجموعة من الأدوار والتي لا يمكن الاتيان بها مجتمعة و منها[iii]:
أ-الدور التعليمي: التواصل التكوين التثقيف الذاتي و الاطلاع لى كل مستجد في الحقل التعليمي، و التمكن في المادة المدرسة و التعمق في المادة العالمة(s.savant) و التمكن من التكنولوجيات الحديثة و تطبيقاتها حتى لا يشر بالملل الناجم عن التدريس التقليدي.
ب-الدور الاحترافي: نقصد به وصول المعلم إلى مرحلة التلقائية في التدريس، و القدرة على مواجهة المواقف مهما كانت معقدة و صعبة سواء مع المتعلم أو المناهج التعليمية.
ج-الدور الفعال: أي التعلم النشط (Active-learning) الذي يلبي الحاجات الفردية للمتعلمين و استثارة دافعيتهم للتعلم من خلال استراتيجيات مناسبة يقوم بها المعلم لتلبية حاجات المتعلمين الفردية.
د-دور الباحث: البحث عن كل ماهو جدبد متعلق بموضوع دراسته و إشراك المعلم الطلاب في عملية البحث و الاكتشاف من خلال جمع البيانات و المعلومات و غيرها.
ر-الدور الاجتماعي: هو رائد إجتماعي يسهم في تطوير المجتمع و تقدمه عن طريق التربية و التعليم، وغرس القيم الاجتماعية في المتعلمين.
ه-دور المستفيد من التقنيات الحديثة: تعد التقنيات الحديثة من أهم الاتجاهات الحديثة في إعداد المعلم من خلال ما توفر هذه التقنيات من أجهزة لتنفيذ البرامج مثل أجهزة العرض و الكومبيوتر و شبكات الانترنت و تشجع المعلم للتدريس بطرق و أساليب حديثة و استخدام التقنية لتنفيذ البرامج أكثر سهولة و يسر.
و-دور الديمقراطي: خلق جو من الود بينه و بين طلابهو بين الطلاب أنفسهم من خلال الحوار المناقشة التساؤلات إحترام الآراء ، يعني إشتراك الطلاب بطريقة إيجابية و فاعلة في الأنشطة التعليمية المتنوعة دون فتح مجال للفوضة و الضوضاء داخل الصف، و تشجيع روح المشاركة بين الطلاب و العدل بينهم.
ي-الدور التنموي: يشكل المعلم المصدر الأول للبناء الحضاري و الاقتصادي و الاجتماعي للأمم من خلال إسهاماته الحقيقية في بناء البشر ، و هذا ما عبّرت عنه نظرية رأس المال البشري(human-capital)[iv]فكلما نجح المدرس في رفع مستوى التعليم ارتفعت معه مستويات المعرفة و بالتالي تحسين خصائص راس المال البشري الذي يقدم خدمة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
يتم تحليل مهام المعلم و أعماله و أدواره لتحديد الكفايات المطلوبة و ذلك لزيادة التحكم في العملية التعليمية، و من أدواره أنه موجه للنشاط التعليمي ، و ناقل للمعارف و مدير لفصله، و غيرها من الأدوار و قد اعتمدت كلية التربية في جامعة بستبرج بأمريكا (university-of-pittsburgh) نموذجا لهذا المرجع حصرته في ستة مجالات للكفايات تحت كل منها عدد من الكفايات الفرعية نكتفي بذكر المجالات دون التطرق للكفايات الفرعية تحت كل مجال وهي:[v]
-المجال الأول: المعلم ناقل للمعرفة
-المجال الثاني: المعلم مدير للنشاط التعليمي
-المجال الثالث: المعلم مصمم و مصدر لعملية التدريب على التعليم
المجال الرابع: المعلم مصمم و مدير لمهام التعليم
المجال الخامس: المعلم مرشد
-المجال السادس: المعلم و تفاعله مع الآخرين
[i]-ينظر خالد مطهر العدواني إعداد المعلمين قبل و أثناء الخدمة،، منتدى الباحث التربوي و موقع كنانة أونلاين، 17مارس2011،الرابط:
[ii] -الربيع بوجلال، إعداد المعلم، المأمول و الراقع، مجدلة العمدة في اللسانيات و تحليل الخطاب، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،المجلد1، العدد1، ص ص(258-274)، جوان2017، ص266
[iii] -نفسه، ص267-269.
[iv]-الفكرة الأصلية لرأس المال البشري إلى آدم سميث في القرن الثامن عشر. تم نشر النظرية الحديثة بواسطة جاري بيكر (Gary Becker)، الاقتصادي والحائز على جائزة نوبل من جامعة شيكاغو ، جاكوب مينسر ، ثيودور شولتز . نتيجة لعمله في وضع المفاهيم والنمذجة باستخدام رأس المال البشري كعامل رئيسي ، مُنحت جائزة نوبل للاقتصاد لعام 2018 https://emirate.wiki/wiki/Human_capital
[v] -بوسعدة قاسم، سلام بوجمعة، إعداد المعلم في ضوء الاتجاهات التربوية الحديثة، مجلة العلوم الانسانية و الاجتماعية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، عدد4 خاص، ملتقى التكوين بالكفايات في التربية 2011، ص251-252.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
محاضرة -الوسائل التعليمية و تقنياتها:
تعريف:
هي الوسائل المستخدمة في عملية التعليم، و تسمى أيضا المعينات التربوية نظرا لما تقدمه من عون للمتعلم في عملية الفهم أو وسائل الايضاح نظرا للدور الذي تؤديه فيما يقوم المعلم بشرحه.
و قد تم تصنيفها إلى عدة معايير منها :حسب طريقة الحصول إليها/حسب نوعية العرض/حسب مخاطبتها للحواس/حسب الخبرات:
-حسب طريقة الحصول عليها: قد تكون جاهزة(الأفلام المتحركة، الخرائط التي لا ينتجها الطلبة بل تنتجها شركات متخصصة)،و قد تكون مواد مصنعة يقوم بصنعها المعلم أو الطلاب(رسومات شرائح خرائط بيانات).
-حسب نوعية العرض: عوض ضوئي (أفلام أشرطة..)، وسائل لا تعرض ضوئيا (مجسمات خرائط..).
-حسب مخاطبة الحواس: سمعية، بصرية، سمعية بصرية، ملموسة.
-حسب الخبرات: التي يمر بها المتعلم أثناء تعليمه، و قد وضع إدغار ديل () مخروطا رتب فيه الوسائل التعليمية من القاعدة إلى القمة، ففي القاعدة نجد خبرة مباشرة أقرب إلى الفهم ، ثم يتدرج في صعوبة الفهم نحو قمة المخروط لأنها تعتمد علة رموز لفظية مجردة كما في الرسم أسفل[i]:
1/الرموز اللفظية
2/الرموز البصرية
3/التسجيلات الصوتية
4/الصور المتحركة الافلام
5/المعارض المتاحف
6/الدراسات الميدانية الرحلات
7/العروض العلمية
8/الخبرات الممثلة
9/الخبرات المعدلة
10/الخبرات المباشرة(الممارسة الواقعية)
شكل (1)مخروط الخبرة لإدجار ديل Edgar Dale
المصدر: المكتبة الرقمية السعودية(SDL) https://portal.sdl.edu.sa/arabic
لقد صنّف إدجار ديل الوسائل التعليمية علي أساس الخبرات التي تهيئها الوسائل في كتابه ” الطرق السمعية والبصرية في التدريس-Audio-visual Methods in Teaching ” في شكل مخروط سُمِّي مخروط الخبرة (Cone of Experience). ويعتبر إدجار ديل ( E.Dale) من التربويين الذين قدموا مساهمات رئيسة في تطوير تكنولوجيا التعليم الحديثة. فقد طور مخروط الخبرة الذي يعرض تشبيهاً بصرياً للمستويات المحسوسة والمجردة من طرق التدريس والوسائل التعليمي, ويعد أول محاولة لبناء أساس منطقي لاختيار الوسائل التعليمية اشتمل على نظرية تعلم واتصالات سمعية بصرية, وكان ذلك عام 1964م.
وقد بني المخروط على سلسلة تبدأ بالأشياء المحسوسة وتنتهي بالأشياء المجردة, واعتقد ديل Dale أن الرموز والأفكار المجردة يمكن أ، يفهمها المتعلم ويتذكرها بسهولة أكبر إذا كانت مبنية علي خبرات محسوسة. وقد وضع في قمة المخروط الخبرات المجردة كالرموز اللفظية والبصرية , وفي قاعدة المخروط الخبرات الملموسة الحسية الواقعية.
1.4. فوائد استخدام الوسائل التعليمية في التدريس:
للوسائل التعليمية فواكد كثيرة في العملية التعليمية منه[ii]ا:
-توفير خبرات بديلة
-تكوين المدركات بصورة صحيحة: مثلا عرض شريط حول حيوان الزرافة تكوين صورة صحيحة للمدركات في أذهان المتعلمين أكثر من الشرح و الوصف فقط.(ليس الخبر كالمعاينة).
-مقابلة الأعداد المتزايدة من المتعلمين: يتمكن أكبر عدد من الطلاب من الاستفادة الحقيقية بفضل وسائل التعليم.
-جذب إنتباه المتعلمين:
-توفير الوقت:
2.4. قواعد أساسية لاختيار و استخدام الوسائل التعليمية:
من أهمها[iii]:
-ينبغي أن تحقق الوسيلة أهداف الدرس: لكل وسيلة ما يناسبها من الأهداف.
-البعد عن التعقيد: التعقيد يؤدي إلى صعوبة الفهم
-يجب أن تناسب الوسيلة مستوى المتعلمين:
-توفر عنصر الأمان في الوسيلة: عقرب أو حيوان قاتل أو جهاز مكهرب...
-التخطيط لاستخدام الوسيلة: تفادي الاستخدام العشوائي الذي يؤدي إلى نتائج سيئة و لا يحقق الأهداف.
-تجريب الوسيلة : قبل الدخول إلى الدرس لتفادي الفشل ، و الاحراج، و فقدان ثقة المتعلم.
-توجيه المتعلمين إلى طريقة إستخدام الوسيلة.
-متابعة أثر الوسيلة: في نفوس المتعلمين و متابعتهم بالأسئلة و تعديل الأخطاء للتأكد من بلوغ الهدف.
[i] - علم الدين عبد الرحمن الخطيب، أساسيات طرق التدريس، الجامعة المفتوحة، ليبيا، ط2، 1997، ص157.
[ii] -ينظر علم الدين عبد الرحمن الخطيب، أساسيات طرق التدريس، الجامعة المفتوحة، ليبيا، ط2، 1997، ص169-173
[iii] -نفسه، ص173-175
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- معلم: Ahmed Dahmani